
مرحباً بك يا صديقي
عادة أبدأ أعداد سلسلة أحاديث الشُرفات بهذه العبارة .. أنت مرحب بك دائماً بالطبع 🙂 ولكني أريد أن أوضح لك أن هذا عدد جديد من سلسلة المصطبة وهي مخصصة لأسرد لك بعض ذكرياتي التي أراها تستحق أن تُذكر .. هذا أمر نسبي بالطبع وأنا أكثر حكمة من أن ألعب دور الرجل الحكيم هنا.
ما أكتبه في هذه السلسلة نوع من السيرة الذاتية الانتقائية لكي لا أحطم أعصاب القارئ .. قليلون من يستطيعون أن يثبتوا أن أيامهم لا تخلوا من حدث ما يستحق الحكي أو التسجيل .. عدا ذلك لا يوجد إلا خلاصات ما تأتي به الأيام علينا والحمد لله على كل حال.
في الغالب أضع تاريخ الذكرى عند بداية كل عدد من المصطبة ولكني سأخرج عن المألوف هذه المرة والسبب أني سأتكلم عن بضعة ذكريات صغيرة ومتفرقة وما يربط بينها هو الخطر .
وأنا أقصد بهذه الكلمة تلك الحوادث التي تأتينا فجأة .. أعاذك الله منها .. والتي قد تسبب أذى ما قد يمتد لفقدان الحياة نفسها وإن شاء الله أن يُنجيك منها فلن تنساها ما حييت.
ونحن كبشر لدينا آلية جاهزة لمواجهة الخطر وهي الابتعاد والهرب ولكن .. لأسباب مختلفة .. قد لا تجد وقتاً ولا كيفية لفعل هذا.
هناك أنواع من الخطر من المفترض أن لا تهرب منها بل ومن الضروري مواجهته .. وأنا أقصد هنا تحديداً الخطر الذي يتعرض له جزء من المجموعة ليعيش البقية في سلام وسكينة وإلا فلن تكون هناك حياة يهواها أحد.
لن أطيل المقدمة أكثر .. هذه مجموعة من المواقف التي تعرضت لها خلال حياتي وما زلت أتذكرها .. مواقف جعلت الأدرنالين يملأ دمي ويقرع أُذناي بنبضي وأصوات لُهاثي.
الدورية الحمراء
أعتقد أن ما جرى قد جرى خلال عام 2002 .. كنت في ذلك الوقت في الخدمة الالزامية في قطعة عسكرية قريبة من العاصمة دمشق ..
كانت خدمتي إدارية .. أي أن هناك دواماً ينتهي في ساعة معينة وبعدها لا يوجد عندي أي التزامات إلا في أوقات قليلة .. لذلك كنت أنتهز فرصة العطلة الأسبوعية لأغادر القطعة الى العاصمة خلال ظهر الخميس لأعود ليل الجمعة.
كنت أركب في باص النقل العسكري الذي يعود بالرتب المتوسط والصغيرة الى بيوتهم .. وأقصد هنا المساعدين وما شابه.
كان سائق الباص مغرماً بسماع شريط كاسيت معين أثناء سير الباص وكان يشغله بمجرد انطلاقه بحيث تستطيع أن تعرف في أي منطقة يسير الباص بمجرد سماعك لمقطع الأغنية التي وصل اليها الكاسيت .. كانت من تلك النوعيات من الأغاني الذي لا تسمعه إلا في الباصات .. أغاني الدهماء إن جاز التعبير.
وصل شريط الكاسيت الى مقصدي فأسرعت لباب النزول وسرعان ما كنت أقف على طرف الطريق العريض الذي ينتهي بدوار كبير وضعوا مجسماً لطائرة في منتصفه.
تلفّت حولي لأتأكد من خلو الشارع من السيارات وبدأت بالعبور عندما لمحتهم .. دورية من الشرطة العسكرية تتجه نحوي بهدوء .. الحقيقة أنهم لم يكونوا بحاجة لأي عجلة لأنه لا يوجد أي منفذ للهرب .. ورائي سور عال يمتد لمسافة طويلة والشارع عريض وأمامي مسافة لا بأس بها قبل أن أصل للطرف الآخر حيث البيوت والشوارع الجانبية .. ذلك الطرف القادمين منه بالذات.
الفخ كان محكماً بامتياز ….
الحقيقة أنني لا أعرف لم اتخذت قرار المضي في عبور الشارع .. ربما لكي لا أطيل عذاب الرعب والترقب أكثر .
مرت في تلك الأثناء شاحنة طويلة بيني وبينهم ويبدو أنهم كانوا ينتظرون عبورها بشكل كامل ليكملوا سيرهم نحوي، لكن الذي حدث أن الشاحنة قد توقفت .. ترددت لثواني ثم أسرعت للعبور من أمام الشاحنة ومن ثم أكملت الشاحنة سيرها .. وبعد ذلك مباشرة اقتربت عربة ركاب صغيرة مني وقللت من سرعتها بينما كان معاون السائق يفتح بابها ويشير لي بالركوب بسرعة .. وسرعان ما كنت أجلس على إحدى المقاعد وأنا ألهث بانفعال بينما كان المعاون يعاود إغلاق الباب.
ألهث بانفعال ولا أجرؤ على النظر خلف العربة …..
بقيت لي كلمة واحدة هنا … هذا ما حدث بكل الأمانة والسبب من نجاتي من المصير المظلم الذي كان ينتظرني هو الله وحده سبحانه.
جرة غاز صغيرة
الصباح في بدايته وأنا أسير عبر منطقة الجديّدة في حلب قادماً من العزيزة ومتجهاً الى عملي في مكتب البيع الواقع في أحد خانات سوق حلب القديم.
المحلات في الشارع الصغير الذي كنت أسير عبره كان مخصص أكثرها لتجهيز قطع من جسم الخروف لتحضير أكلة المقادم وكنت تسمع هدير النار التي تخرج من أدوات عبارة ماسورة تتصل بطرفها الآخر بجرة غاز صغيرة وتتصاعد روائح مميزة يألفها المارُ بشكل يومي من تلك المنطقة.
كنت أسير وأنا أفكر باستغراق في أمر ما حين تدحرج أمامي شيء بحجم صخرة صغيرة .. دققت فيه لأكتشف أنها جرة غاز صغيرة مشتعلة الفوهة وتتدحرج باتجاهي في اصرار ..
أصابتني حالة من الجمود ولم أدري ما أفعل .. كان هناك صراخ قادم من محل على بعد أمتار مني .. يبدو أنه الأحمق الذي كان يملأ الجرّة بالغاز وتسبب باشتعالها .. وتوقف عدد قليل من الناس حولي وهم ينظرون للمشهد بفضول.
بيني وبينك .. شعرت وقتها بالخجل من أن أركض صارخاً مبتعداً عن الجرّة المشتعلة فتابعت طريقي في شموخ .. واثق الخطوة يمشي متلبكاً :).
اقتربت الجرّة المشتعلة مني وتجاوزتني بعدها ولم تصطدم بقدمي .. التفت ورأيت أنها تابعت سيرها نحو محل خياطة .. الجرّة اللعينة تعرف كيف تنتقي أهدافها بدقة .. قماش وزيوت وأشياء كفيلة بجعل النار تلهو هناك في استمتاع.
لكن صاحبها كان سريع البديهة فركلها وهو يصرخ ويشتم في غضب .. وكانت ركلة موفقة لأنها أبعدت الجرّة عن محله لتطير وتدخل لإحدى العبّارات المغلقة .. والواقع أنها كانت ركلة حمقاء أيضاً لأنها تسببت بأن تستقر مباشرة أمام مروحة تهوية معدنية كبيرة.
هنا بدأ لسان طويل من اللهب بالانتشار في أرجاء العبّارة وتعالى صراخ الناس أكثر.
وضبطُّ نفسي أضحك بصوت عال وأنا أتابع سيري نحو آخر الشارع.
حاجز الصنم
كان ذلك في العام 2012 .. الثورة في سوريا مشتعلة على أشدّها والمعارضة تسيطر على أكثر من نصف مدينة حلب حيث أسكن .. حواجز النظام منتشرة في كل مكان والهدف الكبير هو التنكيل بمن يستطيعون الوصول إليه وزرع الخوف في قلوب الجميع .. تحدثت عن هذا الموضوع باسهاب أكثر في هذا العدد من المصطبة.
جالس في إحدى عربات نقل الركاب “السيرفيس” منتظراً بصبر وترقب وصولي لمكان عملي في شارع فيصل .. وبطبيعة الحال هناك طريق معين تسلكه العربة ولكن في هذه المرة لم يكمل السائق الطريق بشكله المألوف وانحرف فجأة نحو دوار المرأة العربية أو ذلك الذي كنا نسميه دوار الصنم .. يبدو أن انحشار الركاب في السيرفيس لم يكن كافياً بالنسبة له.
المشكلة في هذا الدوار أن هناك حاجزاً من ألعن الحواجز يقبع بجانبه .. مجموعة من الشبيحة الذين هم أوسخ بكثير من أمن النظام.
أشار أحد أفراد الحاجز للسيرفيس بالتوقف .. وأشار لنا فرد آخر بالخروج منه واخراج هوياتنا .. توقف عند هويتي وقرأ تفاصيلها بتمعن كان كفيلاً بإصابتي بشلل رباعي.
معلومك أن كنيتي هي “حريري” وهناك قرى عديدة في درعا جميع سكانها من عائلة الحريري .. درعا المحافظة التي بدأت منها الثورة .. أي أنني معارض محتمل بقوة.
كان عنواني على الهوية هو منطقة في مدينة حلب ومن الواضح من لهجتي أنني لست قادماً من درعا .. ولكن مفهوم البديهيات لن يعمل غالباً مع هذا المخلوق .. وبدأ دقات قلبي بالتصاعد بقوة .. هل سأرى عائلتي مرة أخرى !؟
ثوان كالدهر وأعاد لنا بعدها الهويات وأشار بقرف بأن نركب مرة أخرى … وبعد أن تحرك السرفيس كاد الركاب أن يفتكوا بالسائق بنظراتهم وألسنتهم.
وأنا أقسمت بعدها على أن أنزل وأكمل طريقي سيراً على الأقدام لو لم يكمل السائق طريقه بشكل مألوف وانحرف يساراً متجهاً نحو دوار الصنم وكفّار قريش القابعين بجانبه.
طاخ بووم
ما زلنا في العام 2012 … كنت أسير في منطقة الجميلية بجانب صاحب المكتب الذي كنت أعمل فيه وكنا نتحادث في أمور معينة تتعلق بتطوير العمل .. كان صاحب المكتب من النوع الطموح الذي لا يكف عن التفكير .. وأنا لن أتحدث عنه كثيراً لأن الموضوع يستحق التكلم حوله باسهاب في وقت ما.
كنا نسير في إحدى الشوارع التي تقع في طرف الحيّ والتي تنتهي بالذهاب الى شارع فيصل حيث يقع مكتب العمل وكنا نمر تحديداً أمام أحد الدكاكين المغلقة بدرابية حديدية قديمة عندما سمعنا صوتاً عال قادم من الدرابية التي اهتزت وهمدت بعدها.
تأمل صاحب العمل الدرابية ثم تحدث بكلمات سريعة عن رصاصة اخترقتها في تلك اللحظة وأننا محظوظون بأنها لم تخترق أحدنا أيضاً قبل أن تستقر داخل الدكان.
وأنا لم أجرؤ على النظر نحوها وكان كل ما أريده هو مغادرة المكان بسرعة قبل أن تأتي أختها لتخترقنا هذه المرة وهي تبحث عن مقصوفة الرقبة الأولى.
من أمام قصر الضيافة
تستحق السنة الأخيرة التي قضيتها في حلب الكثير من الحديث عنها لأنها .. بالنسبة لي .. سنة مليئة بالأحداث والمتغيرات .. الواقع أنها كانت فاتحة لسنوات عديدة حافلة بالتغيرات وبتجارب لا تنسى.
من بين تلك التغيرات كان عملي بمكتب يؤدي العديد من الخدمات المتعلقة ببرنامج “الأمين” المحاسبي وهو برنامج معروف ومستعمل بشكل كبير في سوريا.
من بين تلك الخدمات كانت خدمة الدعم الفني وهي تجهيز الحواسب لعمل البرنامج عليها .. وكان زبائننا من أصحاب المتاجر والصيدليات وأعمال أخرى لذلك كانت تقع على عاتق المكتب أيضاً صيانة الحواسب من جميع الأعطال لكي لا يحدث أي مكروه لقاعدة بيانات برنامج المحاسبة.
كنت في ذلك اليوم متجهاً لإحدى الصيدليات التي تقع بالقرب من قصر الضيافة .. وقصر الضيافة هذا هو مبنى أشبه بقصر صغير يقع ضمن حديقة كبيرة وكان هذا المبنى مخصصاً لإقامة رئيس الدولة عندما يرغب بالقدوم الى حلب.
وككل هذه الأماكن التابعة للنظام كانت هناك حراسة كبيرة عليه في هذا الوقت التي كانت الثورة في عزّها.
كان الطريق الى الصيدلية يمر عبر الشارع الذي يقع فيه باب قصر الضيافة الخارجي .. كنت أسير محاولاً عدم الالتفات والتحديق بأي فرد من أفراد الحراسة عندما ناداني أحدهم.
كان شاباً ذو ملامح أمنية بامتياز يجلس على كرسي بجانب الباب الخارجي .. طلب مني هويتي وهاتفي .. أعطيت الهوية والهاتف الذي لم يكن هاتفي بالضبط .. كان هاتفاً عائداً للعمل من طراز نوكيا وبالتحديد ذلك الاصدار القديم الذي يمتلك مصباح إنارة .. الاصدار الخالي من أي خدمات انترنت.
تأمله ذو الملامح الأمنية بخيبة أمل وتصفح قليلاً ما أحسب أنها الرسائل .. ثم حدّق بيّ وهو يبحث .. غالباً .. عن سبب لاعتقالي
الواقع أنه لم يكن يحتاج لأي سبب وكان الظن كافياً لكي يرسلني الى أحد المعتقلات لأصبح فيما بعد أحد صور قيصر.
سألني فجأة الى وجهتي فأخبرته باسم الصيدلية فانفرجت أساريره ولامني على عدم اخباري بذلك من البداية ثم أعطاني الهوية والهاتف وطلب مني أن أسلّم على صاحب الصيدلية.
تابعت سيري غير مصدق أنني نجوت مما كنت على وشك الوقوع فيه .. يبدو أن المخدر الذي يتعاطاه هذا المجرم يأتيه من هذه الصيدلية بالذات لذلك لم يشأ بأن يلومه صاحبها على أي ضرر قد يحدث من عدم وصولي إليه.
طبعاً وكما لا يخفى عليك لم أرجع من نفس الطريق واخترت طريقاً آخر أطول بمراحل ولكنه .. على الأقل .. خال من أصحاب الملامح الأمنية.



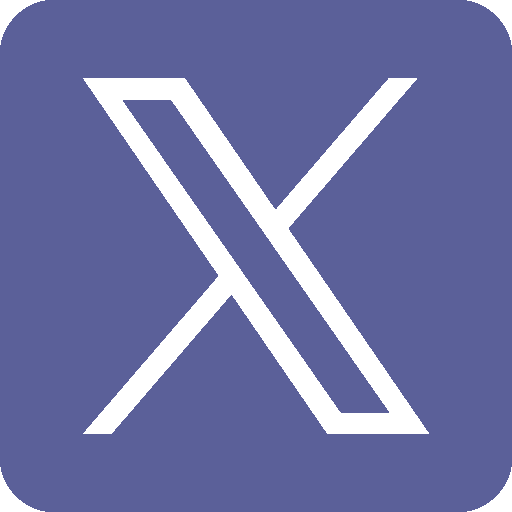





يا أخي أسلوبك في الكتابة مبهر حقيقة.. ❤️
وأحاديثك على رغم مسحة الحزن فيها فهي ممتعة.
هذا كلام أعتز فيه وعلى رأسي وفي قلبي
شكراً على دعمك هشام وممتن جداً لتعليقك
شكرا لك على حسن التعبير، لقد عشت لتوي لحظات في شوارع و ازقة حلب.
العفو … أهلاً وسهلاً بك دائماً وممتن لزيارتك 🙂
تدوينة شيقة… أحسست أنني أشاهد فلماً ما
ولكن لم أفهم قصة الدورية، لماذا هربت من الشرطة العسكرية؟ ألم يكن ذاك يوم عطلة وأنت خرجت من المعسكر بالباص العسكري؟ مالمشكلة في مافعلت؟
أرجو أن توضح أكثر
وشكراً
شكراً لتشجيعك وأنا سعيد أنها أعجبتك … هربت لأن دوريات الشرطة العسكرية لا يعنيها سواء كنت أسير وفق النظام من عدمه … ما يهمهم جمع عدد معين من العساكر لزجهم في السجون