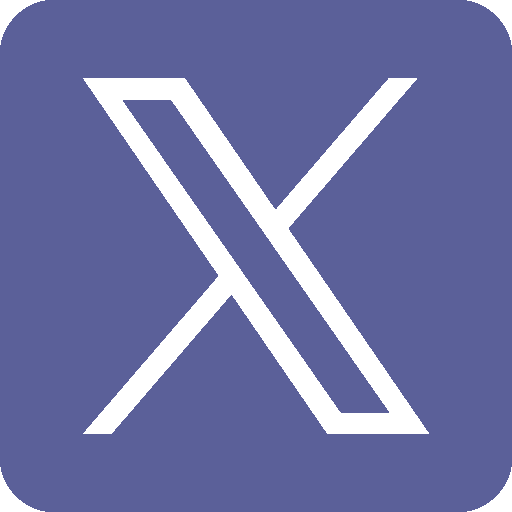هناك حقيقة دامغة غير قابلة لأي نقاش أو محاولة لإثبات عدم صحتها بشكل أكثر حِدة من الحقائق العلمية نفسها، تقول هذه الحقيقة أنني أكره المدرسة بشدة.
قد يكون فعل الكراهية هنا غير معبر بشكل كامل عن حقيقة شعوري ولكن لابأس به طالماً أن الجملة تنتهي بالشدّة كونها كلمة تأكيدية لا بأس بها أبداً.
ذلك الشعور المقبض الذي كان ينتابني حين أستيقظ في الصباح الباكر البارد والذي يزداد بشكل لا يوصف عندما ترتطم بذهني فكرة أنني أستعد الآن للذهاب الى المدرسة …
يا لها من بداية يوم سوداء… تلك البداية التي تشاركني بها السماء المكفهرة التي تنذر بأي لحظة بسقوط المطر .. رائحة وقود السيارات في الشارع المثيرة للغثيان وأصوات أبواق الشاحنات القادمة من بعيد والكتل المتفرقة المتدفقة من الطلاب المتجهة بوجوه جامدة ناعسة وتعسة نحو المدرسة .. المشهد اليومي المتكرر طوال العام الدراسي.
كان مجيء العطلة الصيفية مناسبة سعيدة حقاً لا يجاريها في ذلك سوى أعياد الفطر والأضحى، العطلة التي كانت تمتد لحوالي ثلاثة أشهر شكلت فترة استراحة رحيمة من عذاب سيزيف اليومي الذي كنت أتعرض له طوال العام الدراسي، وحتى هذه الفترة لم تسلم من التنغيص عندما يراودني هاجس أن كل هذا سينتهي وأن أول يوم من السنة الدراسية القادمة آت لا محالة كجزء جديد من فيلم الرعب الذي يبدو أن لا نهاية قريبة له.
بيني وبينك ولا تعد كلامي نوعاً من المبالغة الزائدة عن الحد ولكن برغم سني الصغيرة فلقد كنت أتعامل مع قضية الذهاب للمدرسة على أنها فعل مشابه للذهاب للمعتقل من دون أن ترتكب شيئاً ما يستحق ذلك .. عالم قريب من عوالم فرانز كافكا الكابوسية .. الحقيقة أن ليس هناك مبرر حقيقي لأن يوضع أي أحد في معتقل.
قد تعد هذا الكلام نوعاً من التهويل التي سببته عُقد الطفولة وكراهية أغلب الأطفال الطبيعية للمدرسة، لكن بالنسبة لي كان الأمر يتخطى هذا وفيما بعد ومع تطور أسلوبي في التفكير فهمت أن المدرسة في الدول الشمولية هي المهد الأول لزرع العديد من مبادىء التدجين والترويض ومحو أكبر قدر ممكن من إمكانية نشوء وعي اجتماعي سليم يرفض الخطأ ويعتنق الصواب، وكان هناك الكثير من هذه الأساليب بمستويات مختلفة بدءاً من عريف الصف الذي هو طالب من نفس الشعبة يكون غالباً ابن المدرس أو أحد أقرباء الهيئة التدريسية أو على الأقل شخص انتقي بعناية لكي يؤدي مهمة إبقاء الشعبة الدراسية هادئة في حال غياب المدرس لسبب ما وكتابة اسم أي شخص يخرق هذا الصمت وإعطاء اسمه للمدرس عند عودته، هكذا يتم تأسيسه ليصبح فيما بعد كاتب تقارير ومراقباً للمزاج العام في أي مكان يتواجد به سواء أكان موظفاً أم سائق تاكسي أم حلاقاً.
ذلك الأمر الصارم من المدرس بأن ينحني جميع الطلاب وهم جالسون ويلصقوا وجوههم بأسطح المقاعد ويحيطونها بأيديهم مع توعد شديد لمن يرفع رأسه بأشد أنواع العقاب كنوع من زرع مخاوف مبهمة لمن يجرؤ في المستقبل على التفكير بأن يرفع رأسه ويكف عن طأطأته.
الأمثلة كثيرة جداً ولا مكان كاف لها هنا، بالنسبة لي أزعم أن فكرة معينة كانت تسيطر عليّ قد حمتني من التأثر بكل هذا التخريب المتعمد للعقل والوعي وهي أنني مجبر على المجيء الى هنا وأنني أكره كل تفصيلة أسمعها أو أراها أو حتى أشمّها، ولم تمر هذه الفكرة من دون آثار جانبية طبعاً ولكنها على الأقل أبعدتني عن الاحتمال المرعب بأن أتقبل كل هذا وأعيش به وأعتنقه طوال عمري.
كانت مدرستي الابتدائية تمتلك نظاماً يفرض فصل الجنسين اعتباراً من الصف الخامس، وهذا يعني أنني سأترك أصدقائي الذين كان أغلبهم من أبناء المعلمات والذين بقوا في فترة دوام الإناث وانتقل للدوام في فترة الذكور وقد قمت بذلك لعدة أيام قضيتها وحيداً بلا أصدقاء وكان الوضع في فترة الذكور أشبه بمجموعة من الزومبي المتوحشين الذين لا يكفون على ركل بعضهم وتبادل الضرب عن طريق الحقائب كنوع من التسلية، أصابني هذا بالرعب لدرجة ذهبت بعدها لأمي وأخبرتها بتصميم بأني لن أذهب للمدرسة مرة أخرى، ويبدو أنني كنت مصمماً لدرجة بدأت فيها الاتصالات لحل هذه المشكلة، تعرفون مبدأ أن فلان يعرف فلان وفلان يعرف فلانة ومن أجلي ولن أنسى لكم هذا، وهكذا وجدت نفسي أعود لأصدقائي وأكون الوحيد الذي حظي بهذه المكرُمة من دون أن يكون ابناً لمعلمة وهكذا تكونت الشعبة من أربعة ذكور ونحو أربعين من الإناث.
ولأننا نحن الذكور – كما ترى – أقلية فهذا جعلنا هدفاً لتنمر الفتيات وكنا نأكل علقة كل فترة وأخرى عندما ننسى حجمنا الحقيقي ونتصرف باعتبارنا أحفاد “سي السيد” … بالنسبة لي كنت استعمل استراتيجية الاستسلام التام بحيث تنتهي المعركة قبل أن تبدأ وهذا جنبني مصير أحد الباقين الثلاثة الذي كان ضئيل الحجم وهذا ساعد بعض الفتيات ضخام الجثة على امساكه والتلويح به من قبعة معطفه ودفعني هذا المشهد لنوبة طويلة من الضحك.
وباعتباري من أحد الذكور القلائل الناجين من مذبحة فصل الذكور عن الإناث وباعتباري أقلهم مشاكسة فلقد كنت أجد نفسي في مواقف غريبة منها أن إحدى الفتيات قد طلبت مني أن أصطحبها لبيت زميلة أخرى لكي تشكوها لوالدها، تلك الزميلة الأخرى كانت تعيش مع زوجة أبيها بعد طلاق والديها في بيت قريب من المدرسة، لم تشأ أن تذهب لوحدها فهي فتاة صغيرة بالنتيجة والدنيا شتاء والمساء يهبط بسرعة لذلك وجدت نفسي أسير معها متجهين الى بيت أهل تلك الفتاة، وعندما وصلنا دخلت هي وبقية بانتظارها أمام الباب، عادت بعد دقائق وأخبرتني أن المهمة أكملت بنجاح وأنها شكتها لوالدها …. بعد ذلك بسنوات طويلة كنت أسير مع زوجتي وطفلتي في نفس الشارع ومررت بجانب المنزل وتذكرت تلك الحادثة الطريفة ووقفت أتأمل باب البيت الذي بقي كما هو ولم يتغير ولمحت لافتة مكتوب عليها اسم تلك الفتاة مسبوق بلقب محامية، وقد صارت الآن تستطيع رفع دعوى ضد تلك الفتاة التي شكتها لوالدها باعتبارها شكوى كيدية 🙂.
في أغلب الأوقات وبهاجس الخوف من التأخر عن المدرسة لكي لا ينالني عقاب ما كنت أصلها مبكراً وأقف أمام الباب المغلق منتظراً موعد دق جرس الدخول، كانت هناك فتاة تصل مبكرة هي أيضاً واعتدنا على الصعود والجلوس فوق جدار المدرسة وكانت تجلب معها بعض حبات الجانورك مع بعض الملح المرصوص بورقة صغيرة وكنا نأكلها سوية، وقد استلهمت فيما بعد بعض أحداث حكاية ” ابنة القمر ” التي هي جزء من رواية ” حكايا رحمي فؤاد ” من ذلك المشهد، طبعاً بعد أن استبدلت أحاديث الأطفال بأحاديث أخرى، تستطيع قراءتها لو أحببت بتحميلها من هنا
من الأمور المحزنة التي أتذكرها هي ما جرى مع إحدى فتيات الشعبة التي كانت تجلس في المقعد ورائي، فتاة ضئيلة الحجم لا تكف عن الابتسام، فجأة لم أعد أراها، سألت عنها أحد صديقاتها فضحكت ثم قالت في خجل أنها لن تعود الى المدرسة لأنها خُطبت، سكتُ وأنا أشعر باستغراب وحيرة كبيرة، بعدها بفترة كنت أسير متجهاً الى بيت جدي عندما شاهدتها تجلس على حافة قضبان نافذة حديدة في الطابق الأول من أحد البيوت التي تشرف على الشارع، لم أحييها طبعاً لأن هذا عيب ولأني شعرت بأنها لم تعد تلك التي كانت تكتب الوظائف وتقف أمام السبورة أحياناً لتجيب على سؤال ما، فتاة ضئيلة الحجم تجلس في شرود على حافة نافذة محاطة بالقضبان.
من الأمور الطريفة التي أتذكرها أنني سمعت في البيت خبر وفاة الموسيقار محمد عبد الوهاب من خلال حديث جرى في المنزل حول هذا الأمر، نِمتُ وأنا أفكر بهذا الخبر ثم صحوت في الليل على صوت الجامع القريب وهو ينعي موت شخص ما خيّل إلي أنه محمد عبد الوهاب نفسه، يبدو أنه حدث كبير حقاً حتى يقوم مؤذن جامع الحيّ بمعاملة عبد الوهاب كأنه أحد أفراد الحيّ، وفي الصباح لم أُطق الانتظار وأخبرت المعلمة فور دخولها بأني سمعت نعيَّ محمد عبد الوهاب من جامع الحيّ وغرقت المعلمة بعدها بموجة ضحك طويلة 😊.
وبمناسبة الحديث عن موسيقار الأجيال كانت في الشعبة عندنا فتاة لها صوت جميل وكانت المعلمة في بعض الأحيان تدعوها لتقف أمامنا وتغني، كانت تغني أغنية “ما تفوتنيش أنا وحدي” لسيد مكاوي، صوتها جميل ومعبر وكانت هذه أحد الملامح التي جعلتني أبقى في حدود الجمل الجميل ولا أتخطاها نحو الخراب الفني الذي حصل ويحصل باستمرار.
ولأني كنت من ذلك النوع الهادئ الذي يبتعد عن المشاكل ويحب القراءة كثيراً كان لا بد أن أتعرض بشكل طبيعي للتنمر، وكان مصدر التنمر أحد أبناء المُعلمات في الشعبة، ولد ضخم عدواني لا يكف على الصراخ وعلى إثبات قوته، كنت أنا هدفاً سهلاً بالنسبة له، سهلاً لدرجة أنه لو كان يمتلك وعياً أكبر لما رأى ما يستحق التنمر، هكذا نجح من خلال تنمره في صبّ المزيد من الزيت على نار كراهيتي للمدرسة، عرفت فيما بعد أن والده هو أحد المعتقلين بتهمة انضمامه للإخوان المسلمين، وهي تهمة خطيرة جداً في سوريا ذلك الزمن وفي أي زمن قادم خاصة أننا كنا في نهاية الثمانينات وما حدث كان في أولها، ويبدو أن فقدان الأب وتعيّيره بأن أباه خائن من كل من يريد اثبات ولائه للسلطة بهذا الأسلوب الرخيص قد جعل عدوانيته فوق المستوى الطبيعي.
في الأفلام التي تصور تنمر الصغار على الصغار كان الفيلم ينتهي عادة بأن يندم المتنمر على أفعاله ويصبح شخصاً صالحاً ولكن هذا لم يحدث في حالتي لأنني لم أستطع التخلص منه إلا بعد أن انتقلت للمرحلة الإعدادية ولم أعد أراه كونه كان يسكن بعيداً عن منطقتي وكان السبب الوحيد لوجوده في مدرستي هو أن أمه كانت معلمة بنفس المدرسة.
ولكن النهاية كانت حزينة حقاً، علمت فيما بعد أن أمه قد حصلت على الطلاق من زوجها وتزوجت شخصاً آخر وهذا أدخلها في مشاكل مع أبناءها، وبعد عدة سنوات خرج الأب وأخذ أبناءه ليقيموا معه، وكان آخر ما سمعته أن الابن اعتقل في بدايات الثورة ودخل لأحد المعتقلات، كنت أراه وأنا صغير على أنه متنمر ووغد ولكنه كأغلب من يعيش في مجتمع كانت المدرسة فيه أشبه بمعتقل كان مجرد ضحية بائسة لا أكثر.