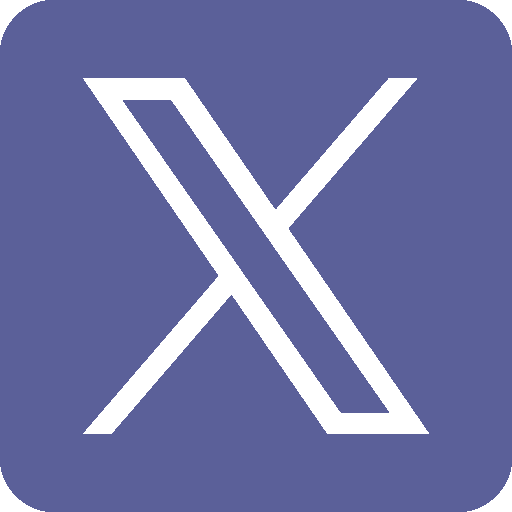النصف الأول من عام 2001
سمعت اسمي ينادى به من خلال مكبر الصوت فأسرعت بالركض وأديت التحية العسكرية بطريقة مضحكة ثم اقتربت واستلمت ورقة الاجازة وأنا في غاية السعادة، كانت هذه أول مرة أحصل فيها على إجازة ليومين أو ثمان وأربعين ساعة على وجه الدقة العسكرية، هذا يعني يوماً مدنياً إضافياً كاملاً أقضيه بين الوجبات اللذيذة ورؤية الأقارب والسير عبر الأحياء التي أحبها في مدينتي حلب.
كنت أؤدي أيام الدورة العسكرية في مدرسة المحاسبة في منطقة مصياف التابعة لحماة والغير بعيدة عن الساحل، الأيام التي أقل وصف يقال عنها بالنسبة لي أنها سوداء على كحلي أنا الذي لم أستطع التعود حتى آخر يوم لي في الجيش على ما يقال عنها أنها حياة عسكرية، الواقع أن توصيفها بحياة هو نوع رخيص من الكذب لأن أداء خدمة الجيش في سوريا معناه أن تموت سنتين من عمرك على الأقل وتذهب بلا أي فائدة وبالعكس تماماً هناك أذى نفسي سيلحقك مهما اعتقدت بعكس ذلك ولا زلت أذكر تلخيص عمي الأكبر رحمه الله لمعنى أن تذهب للجيش بهذه العبارة :
– الجيش هدفه أن تدخل إليه لتخرج منه خائفاً قانعاً بأقل القليل.
ذهبت بسرعة وأخذت حقيبتي وأسرعت نحو الباب الرئيسي، كان عليّ إيجاد وسيلة للسفر لحلب كون أنها المرة الأولى التي أسافر فيها لوحدي وبدون صحبة أصدقاء الجيش، كان هناك أشخاص يقفون منتظرين بدراجاتهم النارية من يريد الذهاب لكراج السفر الصغير الملحق بالبلدة، لم أكذب خبراً ووجدت نفسي أتشبث في الدراجة بقوة بعد أن بدأ سائقها يتقافز ليصل بسرعة فائقة للكراج، وبعدها لم يكن الوصول الى حلب صعباً.
الأمر الصعب كان عند عودتي الى المدرسة، كان هذا في مساء يوم الجمعة، لم أقصد بالصعب هنا فكرة أن عليّ الانتظار أسبوعاً آخر ساعاته كالأيام لكي أعاود السفر مجدداً الى حلب ولكن الصعب جداً كان اكتشافي أن أغلب أصدقائي قد قُطعت دورتهم بقرار مفاجئ وأنهم انتقلوا لدورة تدريبية على أجهزة حاسب وبرامج معينة ليتم فرزهم بعدها لإدارات الجيش في قلب العاصمة دمشق، كانت ليلة سوداء بكل معنى الكلمة قمت فيها بكل كفاءة بتجديد أحزان من بقي ولم يأخذ إجازة مثلي من أولئك الذين رأوهم وهم يحزمون كامل حقائبهم ويغادرون المدرسة بلا رجعة.
هكذا مضت الأيام بأبطأ مما كانت الى أن أتى موعد الفرز الى الأماكن التي سنكمل فيها خدمتنا حتى نهايتها، وبطبيعة الحال ولأنهم أخذوا حاجة الإدارات التي تقع داخل دمشق كان فرز الأغلبية وأنا منهم في القطع العسكرية التقليدية التي تتمركز خارج المدن وكان نصيبي قيادة الفيلق الأول التي تقع على طريق السفر في منتصف المسافة تقريباً بين دمشق ومدينة السويداء.
اكتشفت بعد ذلك أن هناك جانباً إيجابياً فيما حدث وهو أنهم بتواجدهم جميعاً في دمشق قد أصبح عندي من أقضي عطلة نهاية الإسبوع معه بدلاً من أن أقضيها داخل القطعة العسكرية وهكذا كان، في البداية كانوا قد استأجروا بيتاً واحداً ينامون فيه جميعاً، عشرون شخص في بيت واحد !!، ولكي لا يتعرضوا للطرد من البيت كانوا يحرصون على أن لا يخرجوا منه دفعة واحد بل على شكل مجموعات صغيرة بفواصل زمنية معقولة.
وبهذا العدد الكبير والمتنوع من العقول والأذواق والأديان حتى كان لا بد من حدوث مواقف طريفة إحداها أن واحد منهم ولنُسمه زهدي كان لديه كيّف خاص يتمثل في إعداده النارجيلة وجلوسه أمام شاشة التلفاز قبل الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بقليل ووضعه الدش على قناة معينة في القمر الأوروبي والانتظار بعدها في صمت، كانت من تلك القنوات التي تعرض محتوى إباحي لعدة دقائق قبل أن تُشفر وكان ينتظر تلك الدقائق بالذات، ولم يعجب هذا أحد الساكنين ولنسمه عزيز الذي يعتبر ما يقوم به قمة في العيب والإنحراف وكان يهدده دائماً بأنه سيرمي طبق الاستقبال للشارع لو استمر بفعل ذلك.
حتى كانت تلك الليلة التي جلس فيها زهدي لينتظر بدء البث المجاني للقناة وبصحبته كالعادة نارجيلته المشبعة بالمعسل، عينه اليمنى معلقة على الشاشة واليسرى متجهة نحو الساعة .. كان عزيز نائماً على الكنبة المجاورة … أشارت الساعة نحو الواحدة تماماً ومضى عقرب الثواني من دون أن يبدأ البث، هنا بدأ زهدي يشعر بالقلق، هل أقفلت القناة يا ترى !؟ هل أصاب الدش عُطل ما !؟ .. هل هناك من عطّل الدش عامداً متعمداً !؟.
هنا احمرت عينا زهدي وقد تجاوزت الساعة الواحدة بدقيقتين ونظر بغضب نحو عزيز الغافل عن كل ما يجري حوله وبسرعة وبحنكة استل زهدي رجله وضرب عزيز ضربة أوقعته من الكنبة وقام بعدها وهو ينتفض في رعب على حين كان صراخ زهدي يدوي في أنحاء المنزل، وبدء عزيز بالصراخ الغاضب أيضاً عندما فهم ما هناك، هنا بدء بث القناة أمام أعين زهدي الملهوفة الذي حاول تهدئة الوضع ولكن هيهات ويبدو أن عزيز تقصّد رفع صوته وتشتيت ذهن زهدي الى أن انتهت الدقائق المفتوحة وساد التشفير سطح الشاشة.
اكتشفنا فيما بعد أن أحد المقيمين قد قرر عمل مقلب بزهدي فقرّب عقارب الساعة بضع دقائق للأمام لكي يظن أن مشكلة ما قد حدثت ولم يتصور أن يكون عزيز نائماً داخل كادر المقلب وأن تتطور الأمور لهذا الحد.
حوادث عديدة باسمة جرت خلال تلك الفترة، تكفّل الزمن بنسيان بعضها وبقي ما بقي عالقاً في الذاكرة، السهرات والضحكات والمزاح وكثير من الأماني والرغبات التي قالها شباب بدؤوا مشوار حياتهم بالكاد.
أين همُ الآن !؟
لو أطلقنا بعض الخيال من عنانه لقلنا أن بعضهم لا بد أنه جاء لتركيا وبعضهم هاجر لما هو أبعد، قد يكون بعضهم راقداً الآن في أعماق المحيط أو داخل قبر على أطراف دولة أوروبية ما، لا أعتقد أن أحداً منهم قد بقي في سوريا ولكن إن حدث ذلك سيكون إما في معتقل ما أو تحت التراب أو سيكون أحد المحاربين مع قوات المعارضة أو قوات النظام …. قد يكون أحدهم قد ظهر في تسجيل مجزرة حي التضامن الذي لم أجرؤ على مشاهدته كاملاً.
أين هم الآن !؟
هذا سؤال ليس من الصعب تخمين إجابات كثيرة له للأسف.