النصف الثاني من سنوات الثمانينات …..
كانت الحياة من دون كهرباء ثقافة شعبية في سوريا لفترة طويلة تمتد من الثمانينات وحتى آواخر التسعينات لدرجة أن الناس قد تأقلمت واعتادت على نمط الحياة هذا وتفننوا في امتلاك الوسائل التي تتيح لهم إنارة البيوت وتخفيف العتمة من شموع وفوانيس كاز ولوكسات غاز.
مولدات الكهرباء كانت نادرة ومحصورة في بيوت الأغنياء التي كانت تتواجد بدورها في أحياء بعينها، هناك أنواع أخرى من وسائل الإنارة كانت تتواجد هي الأخرى بشكل قليل منها جهاز كنا نقتنيه في المنزل يحتوي على راديو وأنواع من متعددة من الإضاءات المتدرجة القوة ويوجد على أحد جوانبه إضاءة برتقالية تضيء وتطفأ بالتتابع، كان يحتوي على بطارية قابلة للشحن المتكرر ويبدو أنه كان مخصصاً للرحلات وليس للاستعمال داخل المنازل ولكنه وسيلة إنارة بالنتيجة :).
كانت وسائل منع الملل التي لا تحتاج لوجود مستمر للكهرباء محدودة في الزيارات والأحاديث وقراءة الكتب والراديو ولكل منها ذكريات وحكايات طويلة عند الأجيال التي عاصرت تلك الفترة، كانت هذه الوسائل هي الشيء المضيء الوحيد في تلك الفترة.
كنت أضطر أحياناً الى الخروج من المنزل والكهرباء مقطوعة، كان هذا يعني أن تغرق في ظلام شبه كامل منذ خروجك من الباب مروراً بنزولك على الدرج بهدوء محاذراً السقوط ومشيك في الشوارع وحتى وقت عودتك، كانت تجربة غير سارة لطفل لم يتجاوز العاشرة وخصوصاً عندما تنقطع الكهرباء وأنت في الشارع فتنطفأ كل الأضواء وتجد نفسك فجأة ضمن ظلام دامس مع أصوات وطقطقات الاستياء القادمة من المارة ومن الناس داخل البيوت على حد سواء وتضطر الى أن تسير ببطء محاذراً الوقوع في حفرة ما.
لقد جربت شعور أن تمشي في الظلام قبل سنوات طويلة من اصدار أحمد خالد توفيق رحمه الله لأسطورة أرض الظلام ومن ثم روايته الكابوسية في ممر الفئران ، تسير وأنت تسمع أحاديث الناس المتفرقة تخترق أذنك من دون أن ترى متكلميها.
البيوت المُعتمة والناس الذين يجلسون على أرضيّة الشرفات، كانت الراديو تبث أحياناً أغنية الليلة يا سمرة لمحمد منير وأنا كنت أمسك بربطة حذاء جديدة وأرقص على أنغامها والستارة تتراقص هي الأخرى على النسمات العابرة الرحيمة.
بعيداً عن المعاني المقبضة للظلام وبرغم عتمته هناك مناسبة ترتبط به كانت تشعرني دائماً بالفرح والحبور وكانت تبدأ في اللحظة التي يقرر فيها بيت جدي الصعود الى السطح وتبدأ بعدها الاستعدادات لذلك برش السطح بالماء لتنظيفه من الغبار ومن حرارة النهار ثم الصعود بالبِساط والدشكات والتلفاز والبطيخ الأحمر وبعض الجبن وفرشها في وسط السطح.
وتبدأ بعدها السهرة الليلية على وقع أحداث المسلسل العربي أو أصوات الغناء، كان هناك برنامج منوع يبث في ليلة الخميس اسمه “مجلة التلفزيون” كانت له شعبية لأن البرامج المنوعة كانت قليلة في تلك الأيام ، أصوات التلفاز تعلو وتنخفض وإضاءته تنعكس على الوجوه المحدّقة به في نهم.
وبعد وجبة البطيخ والجبن أشعر ببعض التعب فأتمدد مستلقياً أراقب السماء بعينين لا تستطيعا إدراك منتهاها، السماء المنثورة بمئات النجوم وأنا أحاول عدها في كل مرة بلا جدوى، أحاول بعدها بخيالي رسم أشكال من خلال النقاط المتراكمة دون أن أدري أن هناك من رسم قبلي أشكالاً خرج منها بدب أكبر وأصغر.
جربت بعد ذلك بسنوات عديدة رؤية النجوم في السماء وكنت أفشل غالباً لدرجة اعتقدت فيها أنها موهبة خاصة بالأطفال وحدهم وأننا نفقدها عندما نكبر وبقي الأمر كذلك حتى استطعت مرة أخرى رؤية النجوم كما كنت أفعل في صغري.
كان ذلك قبل سنوات وتحديداً في بريّة قريبة من المكان الذي كنت أقيم فيه، وقتها كنت في مشوار ليلي بصحبة صِهري في عربته التي اتجه فيها الى مكان معتم بشكل كامل وتوقف وأطفأ إضاءة العربة وعندها استطعت أن أرى .. في بهجة .. النجوم كما كنت أراها في طفولتي تماماً، كانت موجودة طوال الوقت ومنعها عنيّ الضجيج الضوئي ويبدو أن صهري كان يريد .. هو الآخر .. استعادة ذكريات طفولته مع النجوم فأتى الى تلك البريّة المعتمة، ولبثنا نراقبها لعدة دقائق أدار بعدها المحرك وعدنا أدراجنا.
كانت لحظات عتمة اختيارية نستطيع انهائها في أي وقت وليست من ذلك النوع الذي أُجبر عليه معظم الناس في سوريا لوقت طويل من الزمن .. العتمة التي خلّفت عِتمة أشد وأدهى منها وأمرّ.
والساعة أدهى وأمرّ … صدق الله العظيم.



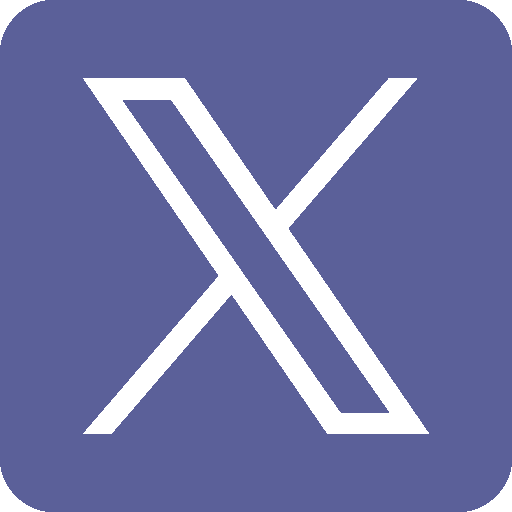





في الحقيقة ما جدبني لقراءة هذه التدوينة هو العنوان، لأنه لي حكاية مع النجوم حتى سميت مدونتي الانيسان